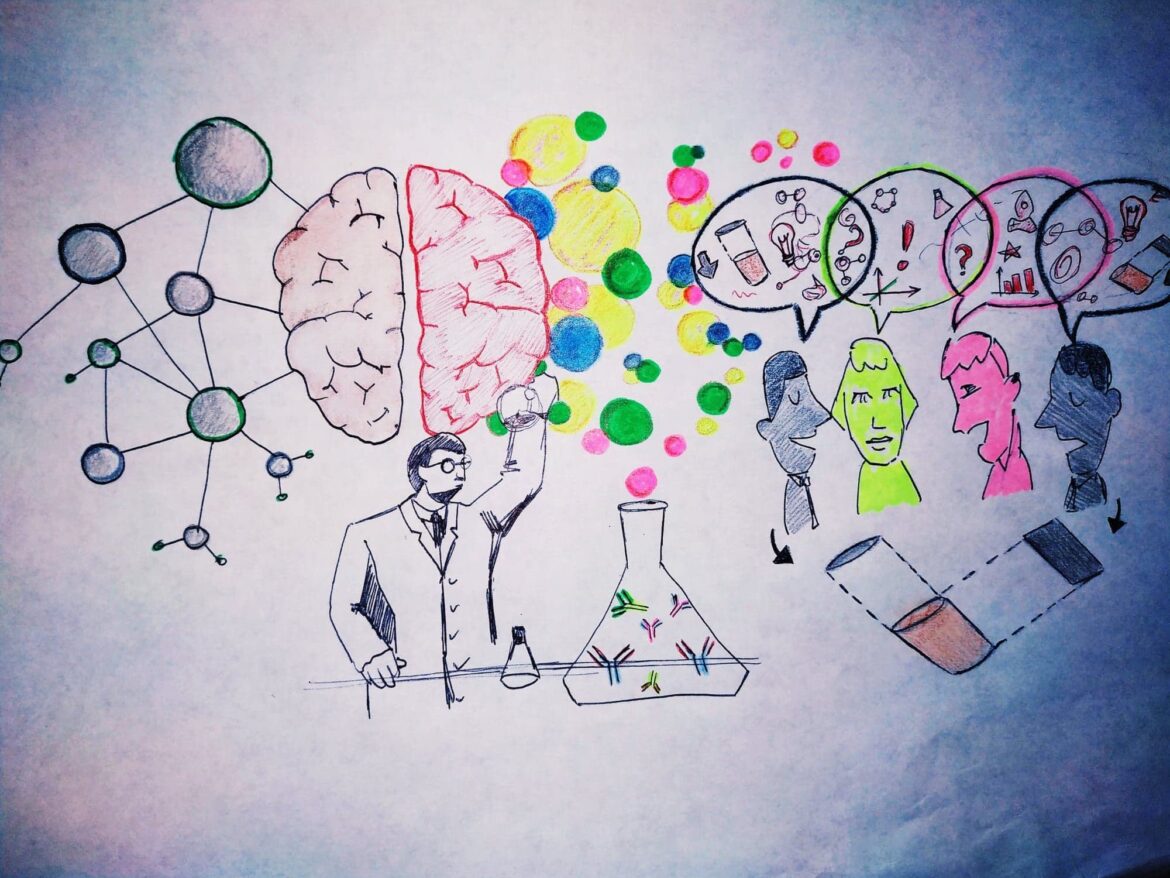حتى وإن لم تكن تتذكر الكثير من حقائق علم الأحياء التي تعلمتها في المدرسة الثانوية فمن المحتمل أنك تتذكر الخلايا اللازمة لتكوين الجنين، البويضة والحيوان المنوي. ربما يمكنك أن تتخيل سربًا من الحيوانات المنوية وهي تتدافع فيما بينها في سباق محموم لتكون أول من يخترق البويضة.
لعقود طويلة، وصفت النصوص العلمية عملية الحمل البشري بهذه الطريقة، إذ تعكس الخلايا الأدوار المتصورة للمرأة والرجل في المجتمع. كان يُعتقد أنَّ البويضة سلبية بينما الحيوان المنوي هو وحده النشط.
بمرور الوقت، أدرك الباحثون أنَّ الحيوانات المنوية أضعف من أن تخترق البويضة وأن الاتحاد أكثر تبادلية، إذ تعمل الخلايا معًا. وليس من قبيل المصادفة أنهم توصلوا إلى هذه النتائج التوصل إليها في الحقبة الحقبة التي سادت فيها أفكار ثقافية جديدة عن الرجل والمرأة.
يعود الفضل إلى العالم لودويك فلِك Ludwik Fleck في وصف العلم كممارسة ثقافية لأول مرة في الثلاثينيات من القرن الماضي. ومنذ ذلك الحين، استمر الفهم في التبلور بأنَّ المعرفة العلمية تتوافق دائمًا مع المعايير الثقافية لعصرها. على الرغم من هذه الأفكار، يسعى الناس، عبر الاختلافات السياسية، إلى الموضوعية العلمية ويواصلون المطالبة بها: فكرة أنَّ العلم يجب أن يكون غير متحيِّز وعقلانيًّا ومنفصلًا عن القيم والمعتقدات الثقافية.
عندما التحقت سارا جيوردانو Sara Giordano ببرنامج الدكتوراه في علم الأعصاب في عام 2001، كنت تحسُّ الشيء نفسه، ولكنَّ قراءة كتاب للبيولوجية آن فاوستو-ستيرلينج Anne Fausto-Sterling بعنوان ”تحديد جنس الجسد“ (Sexing the Body) قادها إلى مسار مختلف، إذ دحض الكتاب بصورة منهجية فكرة الموضوعية العلمية، موضحًا كيف لا يمكن فصل الأفكار الثقافية المتعلقة بالجنس والجندر والجنسانية عن النتائج العلمية. بحلول الوقت الذي حصلتْ فيه على درجة الدكتوراه بدأت تنظر إلى بحثها بصورة أشمل، إذ أدمجت فيه السياق الاجتماعي والتاريخي والسياسي.
من الأسئلة التي يبدأ بها العلماء إلى معتقدات الأشخاص الذين يجرون البحث إلى الخيارات في تصميم البحث إلى تفسير النتائج النهائية، تؤثر الأفكار الثقافية باستمرار على ”العلم“. ماذا لو كان العلم غير المتحيِّز مستحيلاً!
ظهور فكرة الموضوعية العلمية
لم تصبح العلوم مرادفة للموضوعية في نظام الجامعات الغربية إلا منذ مئات من السنين الماضية. في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، اكتسب بعض الأوروبيين زخمًا في تحدِّي النظام الملكي الذي فرضه الدين. أدَّى توطيد نظام الجامعات إلى تحول من الثقة في القادة الدينيين الذين يفسرون كلمة ”الله“ إلى الثقة في ’الإنسان‘ الذي يتخذ قراراته العقلانية بنفسه، إلى الثقة في العلماء الذين يفسرون ”الطبيعة“. أصبح نظام الجامعات موقعًا مهمًّا لإضفاء الشرعية على الادعاءات من خلال النظريات والدراسات.
في السابق، كان الناس يبتدعون المعرفة عن عالمهم، ولكن لم تكن هناك حدود صارمة بين ما يُسمَّى الآن العلوم الإنسانية، مثل التاريخ واللغة الإنگليزية والفلسفة، والعلوم، بما في ذلك البيولوجيا والكيمياء والفيزياء. ولكن بمرور الوقت، ومع ظهور تساؤلات عن كيفية الوثوق بالقرارات السياسية، قسَّم الناس التخصصات إلى فئات: ذاتية مقابل موضوعية. جاء هذا التقسيم مع ظهور تباينات ثنائية أخرى، بما في ذلك الفصل بين العاطفة والعقلانية، وهما أمران وثيقا الصلة ببعضهما البعض. لم يُنظر إلى هذه الفئات على أنها متعارضة فحسب، بل في تسلسل هرمي تعلو فيه الموضوعية والعقلانية. وتُظهر نظرة فاحصة أنَّ هذه الأنظمة الثنائية تعسفية وتعزز نفسها.
ولكن إلى أيِّ مدى يمكن تحقيق الموضوعية في العلم حقًا؟ يرى هاري كولينز وتريفور بينش في كتابهما The Golem: What Everyone Should Know about Science (الغولم: ما يجب أن يعرفه الجميع عن العِلم) أنَّ العلم ليس نتيجة مباشرة للتجارب والملاحظات بل إنه ينبع من تفسير النتائج الغامضة وأن ”الحقائق في العلم لا تتحدث عن نفسها، على الأقل ليس تمامًا“. وذلك لأنَّ نتائج التجارب، وقبولها، ”تتحدد بالحقائق وكذلك بالعوامل الاجتماعية والنفسية“. النشاط العلمي هو نشاط ثقافي يتحوَّل ويُفسَّر ويُستخدم من قبل الناس بطريقة معيَّنة. لا يوجد إطار معياري للعقلانية، إذ تستند مبرراتنا إلى المعرفة المتعلقة بثقافتنا أو بمجتمعنا المُحدَّد.
العلم هو مسعى إنساني
العلوم هي مجالات دراسية يمارسها البشر. إنَّ الأشخاص، الذين يُطلق عليهم اسم الباحثون العلميون، هم جزء من الأنظمة الثقافية مثلهم مثل أيَّ شخص آخر. نحن العلماء جزء من عائلات ولدينا آراء سياسية. نشاهد الأفلام والبرامج التلفزيونية نفسها ونستمع إلى الموسيقى نفسها مثل غيرنا من الباحثين العلميين. نقرأ الصحف نفسها ونشجع الفرق الرياضية نفسها ونستمتع بالهوايات نفسها مثل الآخرين.
من الواضح أنَّ كلَّ هذه الجوانب ”الثقافية“ من حياتنا ستؤثر على طريقة تعامل الباحثين العلميين مع عملهم وعلى ما نعتبره ”حسًّا عامًّا“ لا نشكِّك فيه عند إجراء تجاربنا. وبالإضافة إلى الباحثين العلميين الأفراد، تعتمد أنواع الدراسات التي تُجرى على الأسئلة التي تعدُّ ذات صلة أو غير ذات صلة وفقًا للمعايير الاجتماعية السائدة.
وفي أطروحة الدكتوراه في علم الأعصاب، رأت سارا جيوردانو كيف يمكن أن تؤثر الافتراضات المختلفة عن التسلسل الهرمي على تجارب معينة وحتى على المجال بأكمله. يركز علم الأعصاب على ما يسمى الجهاز العصبي المركزي. يصف الاسم نفسه نموذجًا هرميًّا، إذ يكون جزء من الجسم ”مسؤولًا“ عن الباقي. حتى داخل الجهاز العصبي المركزي، كان هناك تسلسل هرمي مفاهيمي إذ يتحكم الدماغ في الحبل الشوكي.
ركزت بحوثها أكثر على ما يحدث في العضلات الطرفية، لكنَّ النموذج السائد كان يضع الدماغ في القمة. إنَّ الفكرة التي تعدُّ أمرًا مفروغًا منه هي حاجة النظام إلى رئيس تعكس افتراضات ثقافية، لكنها أدركت أنه كان بالإمكان تحليل النظام على نحوٍ مختلف وطرح أسئلة مختلفة، فبدلاً من وضع الدماغ في القمة يمكن لنموذج مختلف التركيز على كيفية تواصل النظام بأكمله وعمله معًا ضمن تنسيق مشترك.
تحتوي كل تجربة أيضًا على افتراضات مضمَّنة – أي أشياء تعدُّ بديهية، بما في ذلك التعريفات. يمكن أن تصبح التجارب العلمية نبوءات تحقق ذاتها. مثلًا، أنفقت مليارات الدولارات في محاولة لتحديد الفروق بين الجنسين. ومع ذلك، لا يُذكر تعريف الذكر والأنثى أبدًا في هذه الدراسات البحثية. في الوقت نفسه، تتزايد الأدلة على أن هذه الفئات الثنائية هي اختراع حديث لا يستند إلى اختلافات جسدية واضحة. ولكن هذه الفئات اختُبرت مرات عديدة لدرجة أنه اكتُشف بعض الاختلافات في النهاية دون وضع هذه النتائج في نموذج إحصائي معًا، وفي كثير من الأحيان، لا يُبلغ عن ما يسمَّى بالنتائج السلبية التي لا تحدِّد اختلافًا كبيرًا.
في بعض الأحيان، تكشف التحليلات التلوية المستندة إلى دراسات متعددة بحثت في السؤال نفسه عن هذه الأخطاء الإحصائية، كما هو الحال في البحث عن الاختلافات الدماغية المرتبطة بالجنس. تحدث أنماط مماثلة من التعريفات المراوغة التي تؤدي في النهاية إلى تعزيز الافتراضات التي تعدُّ أمرًا مفروغًا منه في ما يتعلق بالعرق والجنس وغيرها من فئات الاختلاف التي أنشأتها المجتمع. أخيرًا، يمكن تفسير النتائج النهائية للتجارب بطرق عديدة مختلفة، ممَّا يضيف نقطة أخرى تدخل فيها القيم الثقافية ضمن الاستنتاجات العلمية النهائية.
الاعتماد على العلم في غياب الموضوعية
اللقاحات. الإجهاض. تغير المُناخ. التصنيفات الجنسية. العلم هو محور معظم النقاشات السياسية الساخنة اليوم. على الرغم من وجود الكثير من الخلافات، يبدو أنَّ الرغبة في الفصل بين السياسة والعلم مشتركة من الطرفين. وعلى جانبي الانقسام السياسي، هناك اتهامات بأنه لا يمكن الوثوق بباحثي الجانب الآخر بسبب تحيزهم السياسي.
لنأخذ على سبيل المثال الجدل الذي دار مؤخرًا على اللجنة الاستشارية للقاحات التابعة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة. فقد أقال وزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت ف. كينيدي جونيور جميع أعضاء اللجنة الاستشارية لممارسات التطعيم، قائلاً إنهم متحيزون، في حين ردَّ عليه بعض المشرِّعين الديمقراطيين أنَّ خطوته هذه أدت إلى تعيين أشخاص متحيِّزين في دفع أجندته المتشككة في اللقاحات.
إذا كان من المستحيل إزالة كل التحيُّز، فكيف يمكن للناس تكوين معرفة يمكن الوثوق بها؟
علينا فهم تكوين مجمل المعرفة من خلال عمليات ثقافية تسمح بتعايش حقيقتين أو أكثر مختلفتين، وتمكننا رؤية هذه الحقيقة في العديد من الموضوعات الأكثر إثارة للجدل اليوم. ومع ذلك، هذا لا يعني أنه يجب أن نؤمن بكل الحقائق على قدم المساواة – وهذا ما يسمى النسبية الثقافية الكلية. هذه المنظور يتجاهل حاجة الناس إلى التوصل إلى قرارات مشتركة عن الحقيقة والواقع.
بدلاً من ذلك، يقدم الباحثون النقديون عمليات ديمقراطية للناس لتحديد القيم المهمة والأغراض التي يجب تطوير المعرفة من أجلها. ركزت بعض بحوثي على توسيع نموذج متجر العلوم الهولندي في السبعينيات، حيث تأتي مجموعات المجتمع المحلي إلى الجامعات لمشاركة مخاوفهم واحتياجاتهم للمساعدة في تحديد أجندات البحث. وقد وثق باحثون آخرون ممارسات تعاونية أخرى بين الباحثين والمجتمعات المهمشة أو تغييرات في السياسات، بما في ذلك عمليات إدخال المزيد من المساهمات متعددة التخصصات أو الديمقراطية، أو كليهما.
إنَّ النظرة الأدق للعلم هي أنَّ الموضوعية الخالصة مستحيلة، ولكن بمجرد التخلي عن أسطورة الموضوعية لا يكون المضيَّ إلى الأمام سهلًا. وبدلاً من الإيمان بعلم يعرف كلَّ شيء نواجه حقيقة أنَّ البشر مسؤولون عن البحوث التي تُجرى، وكيف يكون أسلوب بحثها، وما الاستنتاجات المستخلصة من هذه البحوث.
وبهذه المعرفة، تتاح لنا الفرصة لوضع قيم مجتمعية على نحوٍ متعمد لتوجيه البحوث العلمية. وهذا يتطلب اتخاذ قرارات عن كيفية توصل الناس إلى اتفاقات على هذه القيم. ولا يلزم أن تكون هذه الاتفاقات عالمية دائمًا، بل يمكن أن تعتمد على سياق من وماذا قد تؤثر عليه دراسة معيَّنة. ورغم أن الأمر ليس بسيطًا فإن استخدام هذه الرؤى، المكتسبة على مدى عقود من دراسة العلوم من الداخل والخارج، قد يفرض حوارًا أصدق بين المواقف السياسية.
ومن المهم دراسة هذه المفاوضات السياسية والاجتماعية من أجل الاعتراف بأنَّ العلم أعقد من مجرد انتقال خطي من جمع الأدلة إلى النظرية العقلانية. يُستخدم العلم لإضفاء الشرعية على حقيقة متصوَّرة بقدر ما يُستخدم لإلقاء الضوء عليها. لذا، إذا آمنا فقط بأنَّ العلم موضوعي ويكشف الحقيقة، فلن نترك مجالًا لمناقشة القيم التي تؤدي دورًا أساسيًا في تكوين الأدلة العلمية، وسنقع في فخ مناقشة العلم نفسه.
لذلك، لكي تحافظ العلوم على نزاهتها المعرفية، يجب تفكيك أسطورة الموضوعية العلمية. من خلال الاعتراف الفعال بالقيم المتأصلة في إنتاج المعرفة العلمية، يمكننا تعزيز العلوم التي تتسم بالشفافية والمصداقية. في نهاية المطاف، التفاعل بين القيم في العلوم ليس سيئًا بطبيعته. فقط عندما نخطئ في عدِّ العلوم خالية من القيم، نرتكب خطأ إنشاء نظرة نخبوية وغير واقعية للعلوم.